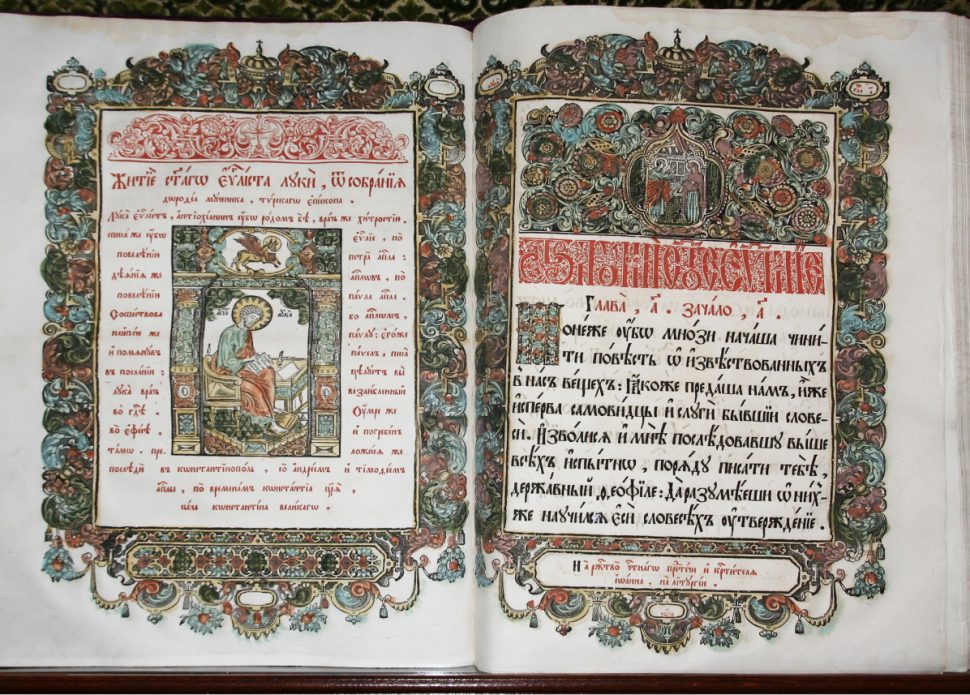
أسهمت الآداب والفنون الروسية إسهامات فريدة في تاريخ الثقافة الإنسانية، وهي إحدى أغنى آداب العالم وفنونه، التي عكست التجربة الحياتية الفريدة للشعب الروسي، وفلسفته، وأخلاقه، ونظرته إلى العالم والوجود في الأطوار التاريخية المختلفة.
ويجمع المؤرخون على أن فترة حكم القيصر بطرس الأكبر (1682- 1725) هي البداية الفعلية لانفتاح روسيا على العالم، وبدء حركة التطور والإصلاح، التي لم تكن مرتبطة فقط بإنشاء أول جيش وأول أسطول نظاميين، وتطوير الصناعات، خاصة صناعات الحديد والنحاس، وتعديل لغة الكتابة، وتغيير التقويم، بل تعدت ذلك إلى إصدار أول صحيفة في روسيا، وتأسيس أكاديمية العلوم، وافتتاح كثير من المدارس والمعاهد.
ولا ينسى التاريخ إسهامات القيصر بطرس الأكبر في مجالات الثقافة والفنون، حيث اتخذ إجراءات مهمة في إطار تطوير الثقافة والفنون، فهو الذي بنى مدينة سانت بطرسبورغ على ضفاف نهر النيف، تلك المدينة التي ازدحمت قصورها بلوحات الفنانين والقطع الأثرية النادرة من مختلف أنحاء العالم، وقد استمر الاهتمام بالفنون والعمارة والأعمال الإبداعية بعد رحيله، حيث تابعت الملكة يكاترينا الثانية مسيرته في البناء والإصلاح
وخلال الحقبة السوفيتية التي امتدت في الفترة من عام 1917 إلى عام 1991، احتلت الفنون والآداب مكانة كبيرة داخل المجتمع السوفيتي، حيث كان الفن يؤدي دورًا مهمًّا في ترسيخ الهُوِيَّة والأيديولوجية الشيوعية الاشتراكية، ويدافع عن قضايا المجتمع السوفيتي النضالية؛ لذا بدأ الاتحاد السوفيتي منذ تأسيسه بإنشاء كلية المتاحف وحماية الآثار، كما بدأت عملية حماية المكتبات ومستودعات الكتب، وبدأ الاعتراف بالأعمال الفنية والأدبية والعلمية والموسيقية كملكية تابعة للدولة.
كما تم تأمين المتاحف الفنية والمعارض الخاصة، مثل متحف الإرميتاج، والمتحف الروسي الكبير، وتأمين الكرملين، وتحويل كاتدرائياته إلى متاحف، وكذلك تحويل القصور الملكية وبعض عقارات ملاك الأراضي إلى متاحف، مع اتخاذ تدابير الحماية للممتلكات التي تضمها هذه المتاحف.
إن الارتباط بين الفن والسياسة في روسيا لم يكن هو الأول من نوعه، فمعروف أن ثمة علاقة وثيقة تجمع بين السياسة والفن، ويحفل تاريخ المجتمعات قديمًا وحديثًا بأمثلة لا حصر لها عن هذه العلاقة الثنائية التي تجمع بين الاثنين، بل إنه لا يمكن بأي حال دراسة الحركة الفنية والإبداعية لأي مجتمع بمعزل عن الجوانب السياسية والأيدولوجية والجغرافية لهذا المجتمع، كذلك لا يمكن إغفال المشاركات النشطة للحكومات أو الأحزاب الحاكمة في دعم العمليات الفنية والأدبية، ووضع السياسات الثقافية، وتصميم والإشراف على المؤسسات الثقافية، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة دعائية لسياسات الدولة، وطرح القضايا التي تتبناها، وتغيير الحقائق القائمة، وتقديم أفكار بديلة، والتأثير في الوعي الجمعي للجماهير، أي إن الفن والأدب كانا في معظم الأحيان خادمين للسياسة، مهما بدا أنهما متعارضان، وأنهما مثل (الماء والنار) لا يجتمعان.
مثال ذلك تلك الموجة من الأفلام عن الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي التي تظهر المواجهة الجيوسياسية بين القوتين الكبيرتين، والتي بدأت في الظهور بعد الحرب العالمية الثانية، ولحسن حظ البشرية لم تتحول إلى صراع مسلح مباشر، أو تتطور إلى صراع نووي، وإن استمرت عقودًا تحت اسم “الحرب الباردة”، لكنها في نهاية المطاف ظلت صراعًا اقتصاديًّا أيديولوجيًّا، وقد استُخدِم الفن للترويج لهذه الأفكار السياسية ودعمها.
كما ذكرنا آنفًا كانت الفنون والآداب تُستخدَم أداةً لتعزيز أيديولوجية الدولة الشيوعية في الحقبة السوفيتية، وبدت كما لو أنها أصبحت بديلًا موضوعيًّا شبه مقدس للدين، حيث حاول النظام السوفيتي أن يستبدل بالأديان التقليدية التي كانت سائدة في المجتمع، أيديولوجية شيوعية مادية تنكر الأديان، وتكون بديلًا للمعتقدات الروحية، وحلت الفنون والآداب محل الدين كوسيلة للسيطرة المجتمعية، وفرض الوصاية السلطوية للدولة، والتحكم في الوعي الجمعي، وفي الوقت نفسه سد الفراغ الروحي الذي يتركه غياب الدين للفرد، وهذا ما ساعد على أن تكتسب الفنون والآداب مكانة رمزية قوية، وأصبحت جزءًا من الحياة اليومية للناس، واستبدلت بالاحتفالات الدينية التقليدية أعيادًا رسمية جديدة، مثل عيد العمال، وعيد ثورة أكتوبر، استُخدِمَ الفن فيها أداةً لخدمة أهداف الدولة وتمجيد الثورة والطبقة العاملة، وتقديم صورة مثالية للمجتمع الشيوعي والعمل الجماعي، وتلميع صورة رموز الثورة (لينين وستالين)، وإظهارهم في صورة الأبطال والقادة العظماء، بل أحيانًا مثل القديسين، حيث انتشرت التماثيل واللوحات التي تُمجّدهم في الساحات العامة والمباني الحكومية.
وخلاصة القول أن الإبداع والفكر الفلسفي حلا محل الروحانيات والأديان، وانتشرت النظريات الفلسفية المادية التي تقول إن الفنون والموسيقى والشعر يمكن أن تكون مصدر إلهام عوضًا عن الدين، وإن الإنسان ليس في حاجة إلى إله أو دين، بل يمكنه سد فراغه الروحي من خلال العمل الجماعي والإبداع، وتحول الفن نفسه إلى دين علماني جديد يعزز قيم الشيوعية ويمجدها.
العلاقة بين المفكرين السوفيت والسلطة في أثناء الحقبة السوفيتية
أولًا- المسار الإبداعي في فترة حكم لينين وستالين (1922- 1953):
فرضت الدولة السوفيتية رقابة صارمة على جميع أشكال التعبير الفني والفكري، وأُجبر الكتاب والفنانون والمفكرون على الالتزام بـمبدأ “الواقعية الاشتراكية”، وهو الأسلوب الرسمي الذي تسيد الفنون والآداب في هذه الفترة، والذي يرتكز على تمجيد الطبقة العاملة، وحياة المجتمع الشيوعي، وكانت السلطة تنظر إلى أي عمل فني أو فكري ينحرف عن هذا الإطار على أنه عمل معادٍ للدولة.
وعلى الرغم من محاولات الدولة المستمرة للسيطرة على الفكر والإبداع، فإن هناك كثيرًا من المفكرين والمثقفين السوفيت الذين رفضوا الانصياع الكامل لهذا الاتجاه الفكري في أعمالهم الفنية والأدبية، إذ رأوا فيه تقييدًا للإبداع وحرية التعبير، وحاولوا مقاومة هذا على نحو مباشر، أو من خلال رموز مستترة في أعمالهم الفنية، وأدى هذا حتمًا إلى مواجهات مستمرة مع السلطة، وأحد أبرز هذه النماذج ما حدث مع الكاتب والشاعر الروسي الشهير “باريس باسترناك”، مؤلف رواية “الدكتور جيفاغو”، الذي رفض منهج الواقعية الاشتراكية في الكتابة، وقد عرّضه هذا لضغوط شديدة، إذ رُفضَ نشر روايته داخل الاتحاد السوفيتي، ومع أنه حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958، فإن الدولة أجبرته على رفض الجائزة والاعتذار عن عدم قبولها.
وهناك بعض المفكرين الذين قرروا اتخاذ قرار التمرد على القالب الفني والأدبي المفروض على نحو غير مباشر، إما من خلال الانعزال في “منفى داخلي”، وإما بمغادرة البلاد تمامًا، وكتابة أعمال نقدية ضد النظام من الخارج، مثل الشاعر “جوزيف برودسكي” الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1987، وعُيّن ملك شعراء الولايات المتحدة الأمريكية عام 1991.
وهناك فريق آخر من المثقفين المعارضين لجأ إلى إنتاج أعمال غير رسمية أو سرية تُعرف بـ”الساميزدات” (samizdat)، وهي مطبوعات غير رسمية، تكتب بخط اليد، وتمرر من قارئ إلى آخر سرًّا، بعيدًا عن رقابة الدولة، وتتناول موضوعات محظورة، مثل القمع السياسي، وحقوق الإنسان، وانتقاد الأيديولوجيا السوفيتية، وكان الشخص الذي يدان بنشر هذه المنشورات أو تداولها يواجه عقوبة قاسية، وقد لخص “فلاديمير بوكوفسكي” فكرة “الساميزدات بقوله: “أخلقها بنفسي، وأحررها، وأراقبها، وأطبعها، وأوزعها، وأسجن من أجلها”.
غير أن بعض المفكرين السوفيت اتخذوا موقفًا مختلفًا ينأى بهم عن النقد المباشر، إذ عملوا على تطوير أفكار فلسفية أو اجتماعية بعيدة عن الأيديولوجيا الرسمية، ولعل أبرز مثال على هذا الفريق هو المفكر والأديب والفيلسوف “ميخائيل باختين”، الذي اشتهر بتحليلاته عن اللغة والأدب، متجنبًا الدخول في مواجهات مباشرة مع السلطة، وإن كانت أفكاره تشكل تحديًا خفيًّا للتيار الرسمي.
ثانيًا- المسار الإبداعي في فترة حكم نيكيتا خروتشوف (1953- 1964):
بعد وفاة ستالين عام 1953، وبدء حقبة خروتشوف، حدثت بعض التغييرات فيما يتعلق بحرية التعبير، إذ خُفِّفت القيود على الفكر والفن نوعًا ما، وظهرت أعمال نقدية أكثر جرأة، لكن هذا الانفتاح كان محدودًا وتحت السيطرة، وعندما حاول المفكرون تجاوز الحدود المسموح بها اصطدموا مجددًا بالسلطات.
ولعل خير مثال على ذلك مع حدث مع الكاتب “ألكسندر سولغنتسين”، الذي كان أحد أبرز المنشقين الفكريين في هذه الفترة، وصاحب العمل الأدبي “أرخبيل الجولاج”، الذي فضح قمع النظام السوفيتي ومعسكرات العمل، وهو العمل الأدبي الذي يرتكز على رسائل شفهية وكتابية لنحو (257) سجينًا، وقد أدى هذا العمل إلى الصدام المباشر بين الكاتب والسلطة، الذي انتهى بنفيه خارج البلاد في 1974.
ثالثًا- المسار الإبداعي في فترة ميخائيل جورباتشوف (1985- 1991):
وفي الثمانينيات، ومع صعود ميخائيل جورباتشوف إلى الحكم، بدأ ما يُعرف بفترة “البيريسترويكا” (إعادة الهيكلة)، و”الغلاسنوست” (الشفافية)، وقد شهدت هذه الفترة انفتاحًا كبيرًا في حرية التعبير، وأصبح المفكرون أكثر جرأة في نشر أعمال تنتقد النظام، وانتشرت المناقشات المفتوحة عن الفساد السياسي خلال الحقبة السوفيتية.
واختصارًا للقول، كان الصراع بين المفكرين والسلطة السوفيتية صراعًا بين حرية الفكر والتعبير من جهة، والسيطرة الأيديولوجية والسياسية من جهة أخرى، لكن، على الرغم من القمع الشديد، استطاع كثير من المفكرين السوفيت أن يبقوا على إبداعاتهم، سواء من خلال المقاومة الصامتة، أو المواجهة المباشرة مع النظام.
يرى النقاد الأدبيون أن خريطة الإبداع الروسي بدت فقيرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، رغم التنوع العرقي والثقافي، وأرجعوا هذا إلى عدة عوامل، منها التوجه السياسي الجديد لروسيا.
وقد انقسم العقد الثامن من القرن العشرين إلى نصفين متساويين بدقة، ساد في النصف الأول منه “مرحلة ركود” فني وأدبي كئيبة في ظل حكم “بريغينيف”، الذي أرسى دعائم ما أطلق عليه “أدب السكرتيرين”، فقد كانت لدي “بريغينيف” نفسه رغبة في أن يكون كاتبًا، وفي عام 1978 نشر سيرة حياته في عمل أدبي بعنوان “الأرض الصغيرة” (اسم جزء من شبه جزيرة كيرتش شهد قتالًا ضاريًا في أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان بريغنيف في أثناء هذا مفوضًا سياسيًّا للمنطقة)، ثم نشر الجزء الثاني الذي حمل اسم “البعث”، والجزء الثالث الذي حمل اسم “الأرض البكر”. ورغم وصف النقاد لهذه الأعمال بأنها لم تكن أكثر من كتابات بيروقراطية كتبها كّتاب السلطة، فإن بريجنيف مُنح أرفع جائزة أدبية سوفيتية، وهي “جائزة لينين”، كما سيطر سكرتيرو اتحاد الكّتاب على دور النشر الكبرى، مثل “الحرس الفتي”، و”الأدب الفني”، و”الكاتب السوفيتي”، كما اتسمت كتابات هذه الحقبة بالاستجابة لغرائز القراء النفسية، كالولع بالقراءات البوليسية، وإثارة الجانب التشويقي، إضافةً إلى أدب الخيال العلمي.
غير أنه كما كان في روسيا أدب رسمي تمثله الدولة، ظهر تيار أدب غير رسمي، خاطر أصحابه بحريتهم، وربما بحياتهم، وقدموا أعمالًا أدبية أصيلة تتماشى مع أفكارهم ومبادئهم الحقيقية، وترسم خطى مستقبلية ثابتة، وتلقى بظلال النقد على الماضي، وبعض هذه الأعمال ظل حبيس الأدراج سنوات طويلة، لكنه في النهاية أثرى الساحة الأدبية العالمية، منها: “أطفال أرباط” لأناتولي ريباكوف، و”سحابة ذهبية قضت الليل” لأناتولي بريستافكين، و”متدفق أبدًا” لفاسيلي غروسمان.
في 25 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1990، ظهر قانون “حرية الدين” في التشريع السوفيتي”، بعد 70عامًا من النضال ضد الدين، ومحاولة جعل الجميع ملحدين، وتقديم الأفكار الستالينية على أنه دين بديل لكل الأديان الموجودة في الاتحاد، وتقييد الممارسات الدينية على نحو كبير، وليس أدل على هذا مما جاء على لسان جوزيف ستالين نفسه: “الماركسية هي دين الطبقة، إذا كنت تريد أن تتعامل مع الكنيسة، تعامل في الوقت نفسه مع الطبقات، مع الجماهير، نحن لينينون، ما نكتبه لأنفسنا هو واجب على الناس، وهذا رمز الإيمان بالنسبة له” .
لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حدث تحول كبير في المشهد الديني، إذ عادت الأديان إلى الواجهة بعد عقود من القمع والإلحاد، واستعادت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية مكانتها بوصفها مؤسسة رئيسة في روسيا، وأصبحت تؤدي دورًا اجتماعيًّا وسياسيًّا، وتمثل الهُوِيَّة الوطنية، وينظر إليها على أنها رمز للتقاليد والقيم الروسية، كما أعيد فتح كثير من الكنائس بعد أن تعرضت للإغلاق في الحقبة السوفيتية، وأصبحت الكنيسة تستمد قوتها من الدولة؛ مما يعزز مكانتها بوصفها دينًا رئيسًا.
إضافة إلى المسيحية الرسمية، أُحيي عدد من الأديان الأخرى، مثل الإسلام، والبوذية، واليهودية، إذ يوجد في روسيا عدد كبير من المسلمين، غير أنه يُنظر إلي الجماعات الدينية غير التقليدية، مثل شهود يهوه، على أنها جماعات متطرفة محظورة، وهناك قوانين صارمة للحد من نشاطها، مثل قانون “ياروفايا”، الذي سُنّ في عام 2016، والذي يفرض قيودًا صارمة على الأنشطة التبشيرية.
لا يخفى على متتبع للشأن الروسي أن روسيا تكثف جهودها في محاولات تغيير النظام الدولي الأحادي من خلال استخدام كل أدوات سياساتها الخارجية، وإعادة رسم علاقاتها الاقتصادية والتجارية، وبناء تحالفات جيواستراتيجية جديدة، وتوظيف أدوات قوتها الناعمة من أجل إعادة ترتيب النظام السياسي الدولي بما يناسبها.
ففي يناير (كانون الثاني) 2022 استُحدثت وحدة في وزارة الخارجية الروسية معنية بوضع آليات عمل الدبلوماسية الشعبية الروسية (القوة الناعمة)، التي تضم العلوم، والفنون، والتعليم، والرياضة؛ وذلك بعد تغيّر الأوضاع الجيوسياسية تغيّرًا كبيرًا.
وفي سبتمبر (أيلول) عام 2022، أصدرت وزارة الخارجية الروسية وثيقة جديدة تحت عنوان “مفهوم السياسة الخارجية الإنسانية لروسيا الاتحادية”، تحدد إطار الدبلوماسية الشعبية الروسية.
وتأتي هذه الوثيقة ضمن جهود روسيا لإعادة تحسين صورتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والحفاظ على الجهود التي بذلتها لسنوات طويلة في دعم قوتها الناعمة دوليًّا، ومعروف أن الجاذبية الروسية صعدت قبل الأزمة الأوكرانية بوضوح، وأسهم في ذلك نجاحها في تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2018، وهو ما انعكس في زيادة أعداد السائحين، والطلاب الأجانب، وقد احتلت المرتبة الـعاشرة عالميًّا في مؤشر القوة الناعمة العالمي عام 2020، والمرتبة التاسعة عام 2022، لكن العاملين على المؤشر العالمي أعادوا تقييمها، وجمدوا ترتيبها نتيجة عمليتها العسكرية في الشرق الأوكراني، وأشاروا إلى انخفاض شعبية روسيا دوليًّا بنسبة 19%، وهو ما دعا روسيا إلى تأكيد ضرورة التركيز على قوتها الناعمة مستقبلًا.
وتركز الوثيقة على تعزيز الثقافة الروسية الشمولية، وضرورة على الحفاظ على المقومات الثقافية الروسية، ووضع اللغة الروسية أولوية للسياسة الإنسانية الخارجية لروسيا، والتأكيد أن يثبت “الكود” الثقافي الروسي مكانته دوليًّا، ومكونات هذا الكود طبقًا لتلك الوثيقة: اللغة، والتاريخ، والفن، والتعليم، والرياضة، ونشر معلومات موضوعية عن تاريخ روسيا القيصرية، وتاريخ الاتحاد السوفيتي.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.