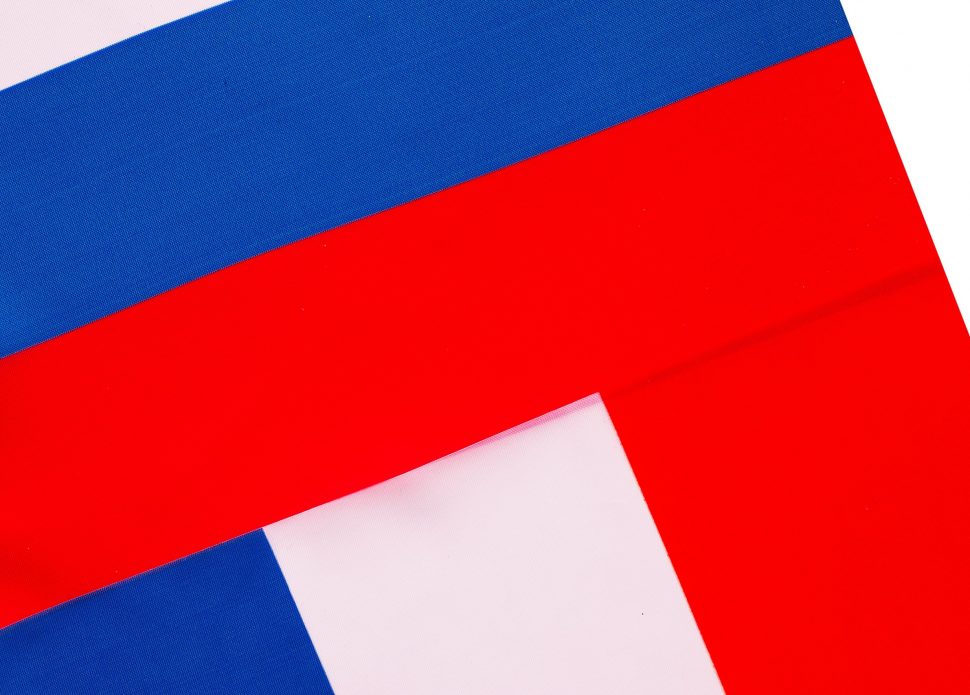
يقول المؤرخ الأمريكي الشهير ألفريد ويتني جريسولد: “إن الذين لا يعتبرون من أخطاء الماضي مكتوب عليهم تكرارها مرة أخرى”. وتحتاج الحكومة الفرنسية -في هذه الأيام- إلى قراءة وفهم مقولة ألفريد جريسولد؛ حتى لا تتكرر المآسي التي عاشتها أوروبا في حقب وأزمنة مختلفة، بدءًا من الحروب النابليونية، والتحالفات الستة، وغزو نابليون الفاشل لروسيا عام 1812، مرورًا بالحربين العالميتين الأولى والثانية، وصولًا إلى اقتراب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) من الأراضي الروسية؛ وهو ما قاد إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تذكير باريس بما حدث للجيوش الفرنسية عام 1812، عندما خسر نابليون بونابرت نحو 680 ألف جندي في محاولته غزو روسيا، وأن كل من يحاول غزو روسيا -كما سعى هتلر- يتلقى هزيمة نكراء. واليوم، هناك أسئلة كثيرة عن الأسباب التي تقف وراء إصرار فرنسا على اتخاذ مواقف معادية لروسيا، لا سيما دعوة باريس إلى تشكيل قوة عسكرية أوروبية، وإرسالها إلى أوكرانيا، وحديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تخطيط روسيا لغزو دول في “الناتو” عام 2030، من خلال تعبئة 3 ملايين جندي روسي، وتصنيع 4 آلاف دبابة روسية، واستيراد وتصنيع نحو مليون طائرة مسيرة من الآن حتى 2030. وتحسبًا لهذه التقديرات، نشرت فرنسا أسلحة نووية بالقرب من الحدود الفرنسية- الألمانية، معلنةً أن بلادها مستعدة لوضع 290 سلاحًا نوويًّا فرنسيًّا لحماية أوروبا من الغزو الروسي، حسب اعتقاده.
ولم يكتفِ الرئيس ماكرون بذلك؛ بل شكّك في نيّة روسيا وقف الحرب في أوروبا، وواصل حشد الدعم الأوروبي وغير الأوروبي من أجل مواصلة الحرب في أوكرانيا، رغم الأحاديث الطويلة التي جمعت بين الرئيس الفرنسي والرئيس بوتين بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مباشرة. وكان البعض يراهن حينذاك أن تكون باريس “جسرًا للسلام” بين موسكو وكييف. فلماذا تصر باريس على الوقوف في الخندق المضاد لروسيا في الآونة الأخيرة؟ ولماذا لا تتحمس باريس لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في وقف الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 3 سنوات؟ ولماذا تصر باريس على الحديث عن الغزو الروسي لأوروبا ليل نهار رغم النفي الروسي، وتأكيد واشنطن أنه لا وجود لأي خطط غزو روسي “لأراضي الناتو” على أرض الواقع؟
تحليل الخطاب السياسي للقيادة الفرنسية تجاه روسيا يؤكد أن باريس أعادت تموضعها الجيوسياسي من جديد بما يصب نحو مزيد من التوتر في العلاقات الفرنسية- الروسية، وهو ما يكشف عن 6 دوافع رئيسة للسلوك الفرنسي ضد روسيا، وهي:
أولًا- تموضع جيوسياسي جديد
يرى مخططو السياسة الفرنسية أن سياسة الانزواء والانعزال التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خاصةً ضد دول الاتحاد الأوروبي وحلف “الناتو”، توفر فرصة نادرة لباريس لترسم لنفسها صورة جديدة تختلف عن الصورة التي كانت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فمنذ عام 1945، كانت فرنسا ضمن الإطار العام التابع للسياسة الأمريكية، إلا في حالات استثنائية نادرة، كما جرى في عهد الجنرال شارل ديغول، الذي انسحب من حلف “الناتو” فترة قصيرة. وباعتبار فرنسا “الدولة النووية الوحيدة” في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، ترى باريس في نفسها أنها يمكن أن تكون البديل عن نحو 100 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أوروبا، ونحو 640 قنبلة نووية أمريكية “تكتيكية” تنتشر في 5 دول أوروبية. ويرى الإليزيه أن هذه “فرصة تاريخية” لم تُتَحْ لفرنسا منذ 8 عقود بأن تكون “زعيمة أوروبا”، وحامية القارة العجوز كما كانت في عهد نابليون الأول الذي خاض معركة غزو روسيا تحت شعار حماية الأوروبيين، وتحديدًا “حماية بولندا”. وتراهن فرنسا من خلال الخطاب السياسي العدائي ضد روسيا أن تلتف حولها الدول والشعوب الأوروبية، خاصةً دول شرق أوروبا، التي لها تاريخ من العداء الطويل ضد موسكو.
ثانيًا- غياب المنافسين
منذ نهاية الولاية الرابعة للمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، تراجعت “القاطرة الألمانية” في قيادة القطار الأوروبي. ويعتقد الرئيس ماكرون -الذي يتبقى له نحو عام فقط في قصر الإليزيه- أن غياب القيادة الألمانية لأوروبا، وعدم اليقين بشأن قدرة المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس على ملء مقعد أنغيلا ميركل، يمنحه فرصة ليكون “صوت أوروبا العالي”، والقائد الذي يحافظ على مصالح أوروبا، سواء ضد روسيا، أو الولايات المتحدة نفسها؛ ولهذا، يتبنى ماكرون خطابًا شديد اللهجة أيضًا ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب على الواردات الأوروبية. ويعزز من شعور باريس بأن الوقت حان لقيادتها الدفة الأوروبية غرق بريطانيا في مشكلاتها الداخلية، والفجوة الكبيرة التي باتت تفصل بين واشنطن ولندن، في ظل العلاقة المتوترة بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر والرئيس الأمريكي دونالد ترمب على خلفية دعم حزب العمال بقيادة ستامر للحزب الديمقراطي وجو بايدن، الرئيس الأمريكي الخاسر في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
ثالثًا- القيادة العسكرية
تقوم المعادلات الفرنسية الجديدة على أن تبني باريس إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا يرسم صورة لفرنسا بوصفها الدولة الأوروبية الأكثر جاهزية من الناحية العسكرية لحماية “البوابة الشرقية الأوروبية” من أي غزو روسي محتمل لأوروبا عام 2030. وتتحدث الصحافة الفرنسية عن هذا الأمر بصراحة شديدة، وتقول إن الجيش الفرنسي هو “الأكثر جاهزية” للدفاع عن أوروبا إذا قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من أوروبا، أو تفكيك حلف “الناتو”؛ لأن باقي الجيوش لم تُختبر خلال العقود الثلاثة الأخيرة إلا من خلال الحرب على الإرهاب التي كانت بقيادة الولايات المتحدة، وأن فرنسا تظل -بدعم شركائها الأوروبيين- الأكثر قدرة على تعبئة الجيوش وجمع السلاح من باقي القوى الأوروبية، خاصةً عند الحديث عن ألمانيا وإسبانيا.
رابعًا- هيبة السلاح الفرنسي
رغم اتفاق الجميع على أن الأسلحة الفرنسية تتميز بقدرات عالية (احتلت صادرات السلاح الفرنسية المركز الثالث عالميًّا بعد الولايات المتحدة والصين عام 2024)، فإن فرنسا لا تزال تشعر بالإهانة الشديدة عندما ألغت أستراليا عقد شراء 50 غواصة فرنسية تعمل بالديزل لصالح شراء 50 غواصة أمريكية- بريطانية تعمل بالطاقة النووية في 15 سبتمبر (أيلول) 2021، وأن فرنسا لم تجد نفسها في التحالف الأمريكي- الكندي- البريطاني- الأسترالي الذي كان في عهد جو بايدن. وترى باريس في “تسخين” الخطاب السياسي والإعلامي ضد موسكو، ودفع الأوروبيين إلى مقاربة أمنية أكثر تسليحًا؛ ما يمكن أن يعود بالفائدة على مصانع السلاح الفرنسية، وشراء الأوروبيين كميات تاريخية من الأسلحة الفرنسية. وكانت فرنسا تدعو دائمًا إلى أن تكون الأسلحة الفرنسية في مقدمة أولويات الجيوش الأوروبية. ومع اقتراب نحو 23% من دول حلف “الناتو” من إنفاق 2% من الناتج القومي على السلاح، ترى باريس أن هذه فرصتها لاقتناص جزء من هذه الكعكة، وأن زعامة فرنسا لأوروبا سياسيًّا وعسكريًّا تعزز مكانتها على غرار مكانة نابليون في أوروبا قبل تلقيه هزيمته في روسيا عام 1812.
خامسًا- تعويض الخسائر الإفريقية
شهدت سنوات الرئيس ماكرون التسع في الإليزيه أكبر خسارة سياسية وعسكرية واقتصادية للنفوذ الفرنسي في الخارج. ومنذ عام 2020، بدأت فرنسا تخسر الدول الإفريقية الواحدة تلو الأخرى، بدءًا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مرورًا بتشاد، وصولًا إلى غينيا وغينيا بيساو، وهو ما يعني أن فرنسا خسرت نفوذها بالكامل في منطقة الساحل والصحراء، ووسط إفريقيا وغربها. كما خسرت فرنسا مليارات الدولارات التي كانت تحصل عليها الشركات الفرنسية من العمل في إفريقيا، وخسر البنك المركزي الفرنسي عائدات “الفرنك الإفريقي” الذي تستخدمه شعوب وسط إفريقيا وغربها. وترى فرنسا أن هناك علاقة مباشرة بين خسارة نفوذها في مستعمراتها الإفريقية وبين عودة النفوذ الروسي في إفريقيا منذ عام 2014؛ لأن كل الدول الإفريقية التي طردت القوات الفرنسية أنهت علاقاتها مع باريس في الوقت نفسه الذي بدأت فيه علاقة خاصة ودافئة مع موسكو لأسباب سياسية وعسكرية واقتصادية؛ ولهذا تشعر فرنسا أن وجود البديل الروسي أمام الدول الإفريقية لم يشجع القادة العسكريين الجدد على الاصطفاف مع روسيا فحسب؛ بل شجَّع أي تحرك ضد النفوذ الفرنسي في إفريقيا؛ ولهذا تجد فرنسا في تصعيد الخطاب ضد موسكو فرصة لتجييش الأوروبيين ضد روسيا، وانتقامًا لخسائرها غير المسبوقة في إفريقيا.
سادسًا- كاليدونيا الجديدة
كانت فرنسا تجاهر بأن علاقاتها مع شعوب ما وراء البحار -خاصةً في منطقة جنوب المحيط الهادئ- تشكل نموذجًا في العلاقة بين الدول الأوروبية من جانب، والأراضي ما وراء البحار من جانب آخر. وكان الحديث الفرنسي ينصب دائمًا على علاقة فرنسا بكاليدونيا الجديدة التي تبعد عن باريس بنحو 16 ألف كم، وانضمت إلى المستعمرات الفرنسية في وقت مبكر من عام 1853 في عهد نابليون الثالث، لكن السنوات الثلاث الماضية شهدت استمرار تمرد شعب “الكاناك” في كاليدونيا الجديدة على السيطرة الفرنسية، والمطالبة بالاستقلال والانفصال عن فرنسا. هذه الخسائر الإستراتيجية في منطقة الإندو- باسيفيك تدفع فرنسا إلى البحث عن مكاسب داخل القارة الأوروبية، واستعداء روسيا.
لعل التاريخ يعيد نفسه بالفعل، فعندما فشلت حملة نابليون في البقاء، واستعمار مصر والشرق الأوسط، عاد بونابرت ليقود سلسلة من الحروب الأوروبية، وهي الحروب التي أُطلق عليها “الحروب النابليونية”. واليوم، هل تدفع خسائر فرنسا غير المسبوقة في إفريقيا وجنوب المحيط الهادئ إلى العودة والتركيز على الساحة الأوروبية، وتصعيد الخلافات من جديد مع روسيا، كما جرى في النصف الثاني من عام 1812؟
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.