
يبدو من خلال التصريحات المُعلنة من الاتحاد الأوروبي وبلدانه الرئيسية، أن هناك موقفًا أوروبيًّا واضحًا وصريحًا في رفض أي “اجتياح” مزعوم من روسيا للأراضي الأوكرانية، وتوافقًا داخل البيت الأوروبي مع الحليف الأمريكي. وهذا الأمر صحيح إلى حد كبير؛ فلا أحد في أوروبا يرغب في أي اهتزاز للموقف الأمني، أو توسع للسيطرة الروسية على أوكرانيا، ولكن عند التدقيق في كيفية مواجهة هذا التحدي، وآليات التعامل مع روسيا بوجهٍ عام، سنجد أن هناك عدة تباينات في المواقف داخل الاتحاد الأوروبي غير الموحد على آلية عمل واحدة.
بدأ التفكير في تأسيس الاتحاد الأوروبي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت أولى خطوات تأسيسه «معاهدة روما لعام 1957» بين (ألمانيا الغربية، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ). كان لدى القادة الأوروبيين في ذلك الوقت شعور بأن الهيمنة الغربية، التي بدأت منذ القرن السادس عشر الميلادي بقيادة أوروبية، في تراجع بعد حربين عالميتين مدمرتين للقارة، ونشوء نظام عالمي ثنائي القطبية بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا جعلهم محصورين بين كلتا القوتين، وهو ما قد يجعل منهم الطرف الأضعف في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

مراسم توقيع معاهدة روما عام 1957، التي شكلت الأساس لقيام الاتحاد الأوروبي) – المصدر: (Council of the EU)
قامت فكرة التجمع على ضم البلدان الأوروبية المتجانسة التي يجمعها تاريخ وقيم مشتركة، وكان أشبه بإعادة إحياء لحدود الإمبراطورية الرومانية المقدسة في شكل عصري جديد. مع مرور الوقت، تطور هذا التجمع، ووجدت فيه أمريكا عاملًا مساعدًا على ضمان الأمن والاستقرار في القارة، وخلق كتلة اقتصادية مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي ومنظومته.
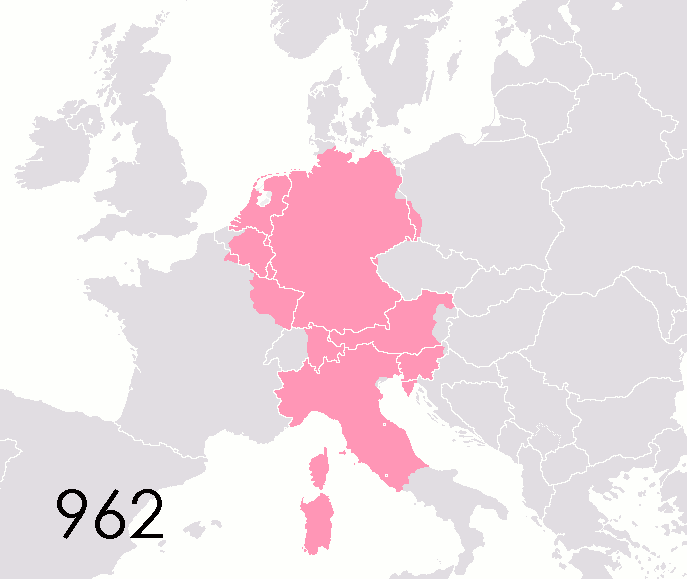
خريطة الإمبراطورية الرومانية المقدسة 962– 1806
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وانتصار المنظومة الغربية الرأسمالية بقيادة أمريكا وحلفائها الأوروبيين، رأت ألمانيا، وبقبول ورضا أمريكيين، أن هناك ضرورة لاستغلال هذا الانتصار بترسيخ هذا التحالف وتحويله إلى اتحاد حقيقي؛ خشية أن يؤدي غياب التحدي السوفيتي إلى تفككه، وعلى هذا الأساس وُقِّعَت «معاهدة ماستريخت» في هولندا عام 1992، التي أسست الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي.
حقق الاتحاد الأوروبي عدة أهداف مرضية؛ فمن خلال هذا الاتحاد ارتبط اقتصاد أوروبا بأمريكا، وكذلك الأمر سياسيًّا وعسكريًّا إلى حد كبير، وقدم نموذجًا سلميًّا للتعاون والرخاء الاقتصادي لشعوب القارة بديلًا عن الصراعات والحروب، وسد الفراغ الذي خلفه تفكك الاتحاد السوفيتي بضم كثير من بلدانه السابقة، أو التي كانت مرتبطة بنظامه السياسي؛ لقطع الطريق على عودة الشيوعية مجددًا، أو خلق أي كيان اتحادي بقيادة موسكو وفق صيغة جديدة. كان الاتحاد مفيدًا أيضًا للقوى الصاعدة الصينية بأن وفر لها الفرصة للولوج إلى الكتلة الأوروبية، من خلال اتفاقيات تجارية تفتح أسواقه مجتمعة، دون الحاجة إلى التفاوض على حدة مع كل دولة.
أمر آخر مهم يعتقد البعض أن الاتحاد الأوروبي نجح في تحقيقه؛ ألا وهو احتواء القوة الألمانية، وحصر طموحاتها في المجال الاقتصادي، بعيدًا عن سياسة التوسع التي كانت تنتهجها على مراحل مختلفة من تاريخها، وأدت إلى صراعات وحروب مستمرة في القارة، وهو ما أسمته أستاذ العلوم السياسية في جامعة برلين، هيلغا هافتندورن (Helga Haftendorn) خلق “ألمانيا الأوروبية- Europeanized Germany” المتمسكة بالتعاون الأوروبي، والحفاظ على السلام بدلًا من سياسة “أوروبا الألمانية- German Europe”[1].
يمكن القول إن الاتحاد الأوروبي خلق نجاحات كثيرة لا يمكن إنكارها، وكان عنصرًا مساعدًا على تمتع أوروبا بسلام دام سبعة عقود، باستثناء بعض الحروب الصغيرة الناتجة عن تفكك الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا السابقة. كما أنه حقق رخاءً اقتصاديًّا وتعاونًا بشكل سلمي لم تشهده القارة عبر تاريخها الذي يصفه كثير من المؤرخين بالدموي.
بلغ عدد دول الاتحاد الأوروبي قبل انسحاب بريطانيا 27 دولة، بمساحة إجمالية تبلغ 4,476,000 كم²، وعدد سكان يقدر بنحو 446 مليون نسمة[2]، وناتج محلي إجمالي تفوّق عام 2017 على نظيره الأمريكي، حيث بلغ 15.3 تريليون يورو. أكثر من 64% من حجم الإنتاج الأوروبي يتم تداوله داخل بلدان الاتحاد، كما أنه أكبر اقتصاد ومصدر في العالم مع الولايات المتحدة والصين[3].

خريطة الاتحاد الأوروبي 2022
يعاني الاتحاد الأوروبي الآن- شأن أي منظمة إقليمية- عدة أزمات تعوق تقدمه وتطوره وفق الخطط المأمول الوصول إليها، إلا أن هذه الأزمات قد ازدادت حدتها قبل بدء العقد الماضي مع الأزمة المالية العالمية، ثم أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، ولم يلتفت أحد إليها، أو يسعى إلى علاج ناجع لها، حتى بدأ العقد الجديد بأزمة أخرى كان عنوانها جائحة كوفيد-19، التي كشفت عما يمكن وصفه بجوائح عدة كانت كامنة داخل كيان هذا الاتحاد بحاجة إلى حدث كبير لتطفو على السطح، ويراها الجميع.
كشفت هذه الأزمة عن واقع الاتحاد الأوروبي، وضعف بنيته الداخلية، وهشاشة التنسيق بين أعضائه. كما أظهرت خللًا كبيرًا في قدرته على العمل بكفاءة تحت الضغط، فبدا الاتحاد وكأنه ماكينة تعمل بشكل جيد جدًّا في ظروف مثالية، وإذا حدث أي تغير فيها تتعطل ولا تصبح قادرة على العمل، أو تتراجع قدرتها إلى حد كبير. كان هذا الخلل واضحًا لكثير من المراقبين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، بل حتى للمواطنين العاديين، حيث عبّر 62% من الأوروبيين في استطلاع رأي لمركز بيو للأبحاث في مارس (أذار) 2019، عن عدم رضاهم عن سياسات بروكسل التي وصفوها بأنها لا تفهم ولا تستوعب متطلبات مواطني الاتحاد، ولا تعمل بفاعلية[4].
كانت ألمانيا راغبة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، واستعادة وحدتها الداخلية، في ترسيخ تلك الوحدة وتأمينها، مستغلة حالة الضعف والفوضى في روسيا من خلال ضم بعض البلدان الشرقية؛ لتشكل حزام أمان لها، وخط دفاع أول أمام روسيا إذا نهضت من جديد. تحديدًا، كان التوجه الألماني منصبًا على (المجر، والتشيك، وسلوفاكيا، وبولندا، وبلدان البلطيق) لتكون مرتبطة سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا بالمنظومة الأوروبية؛ ومن ثم تحت التأثير الألماني، بما يؤدي إلى ضمان سلامة أمنها القومي.

بلدان المنظومة الشرقية السابقة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي بدعم ألماني
في ظل الوجود البريطاني في الاتحاد، والتأثير الأمريكي الكبير فيه، لم يكن لمثل قرار كهذا أن يكون ممكنًا دون موافقة أمريكية ربطتها الأخيرة بضم بلدان شرقية أخرى لم تكن تشكل قيمة جيوسياسية أو اقتصادية للاتحاد؛ بل كانت عبئًا عليه، كما أن هناك تباينًا ثقافيًّا كبيرًا معها. وتحت هذا التأثير والضغط توسع الاتحاد توسعًا غير مدروس شرقًا، خلافًا لكل مخططاته، وضم كثيرًا من بلدانه التي لم تحقق نجاحًا أو تطورًا يُذكر، ولا يشعر مواطنوها بالرضا عن الاتحاد، مثل بلغاريا ورومانيا، وفي الوقت نفسه كان هناك شعور من مواطني بلدان الاتحاد الشمالية الغنية بأن أموالهم تذهب إلى بلدان “فاشلة”، بدلًا من أن تُنفق عليهم.
ذكر المؤرخ الروسي أرمين غاسباريان، في كتابه الشهير «روسيا وألمانيا.. أصدقاء أم أعداء»، موقف الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشُّـوف، من المستشار الألماني كونراد أديناور، حيث رفض التعامل معه، حين قال: “لن نقبل أبدًا التعامل مع أديناور ممثلًا لألمانيا. وإذا سألتموني لماذا؟ فإجابتي هي أنه إذا نزعت عنه سرواله ونظرت إلى مؤخرته، فيمكنك أن ترى أن ألمانيا منقسمة. أما إذا نظرت إليها من الأمام، فيمكنك التأكد أن ألمانيا لن تنهض أبدًا”[5]. بعيدًا عن هذا النقد اللاذع إلى حد الفجاجة، الذي اشتهر به خروشُّـوف، فإن وضع الاتحاد الأوروبي يبدو- إلى حد بعيد- قريبًا من هذا الوصف.
كشفت الأزمة المالية عام 2010، عن وجود انقسام داخل أوروبا بين الولايات الشمالية، بما في ذلك (ألمانيا، وفنلندا، والنمسا، وهولندا)، والدول الجنوبية الأكثر مديونية، وخاصة (إيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والبرتغال). ألقى الشماليون باللوم على طرق الإنفاق الجنوبية في التسبب في الأزمة، في حين اتهم الجنوبيون جيرانهم الشماليين بعدم التضامن، أو حتى بالقسوة عندما ربطوا قيامهم بعملية الإنقاذ المالي بشروط مرهقة جدًّا، حسب الدبلوماسي الأمريكي فيليب إتش غوردون (Philip H. Gordon)، والباحث جيريمي شابيرو Jeremy Shapiro))[6]. لم يكن أي من التشخيصين دقيقًا بشكل كبير، لكن كلا الجانبين قدم قضيته على أنها قضية أخلاقية، ومع مرور الوقت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السياسة الأوروبية. ظهرت ديناميكية مماثلة بين شرق أوروبا وغربها خلال أزمة اللاجئين عام 2015. رفضت الدول الشرقية، مثل بولندا والمجر، استقبال اللاجئين، واتهمت جيرانها الغربيين بمحاولة تمييع تراثهم المسيحي، في حين ينظر الغربيون إلى هذه الدول- بشكل متزايد- على أنها استبدادية، ولديها كراهية تجاه الأجانب.
على الرغم من استبعاد تفكك الاتحاد الأوروبي، فإن الانقسام الداخلي قد يتعمق ويتحول إلى أحزاب أربعة داخلية؛ حزب بقيادة “التحالف” الفرنسي- الألماني”، وتحت مظلته كل من (بلجيكا، ولوكسمبورغ، وإيرلندا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وبلغاريا، ورومانيا)، كتلة ثانية تضم (إيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والبرتغال، وكرواتيا)، وكتلة ثالثة تضم (بولندا، والمجر، والتشيك، وليتوانيا، وإستونيا، ولاتفيا)، وكتلة رابعة تضم (هولندا، والدانمارك، والسويد، والنمسا، وفنلندا). تمثل الكتلة الأولى الداعين والداعمين لمركزية أوروبية، في حين تمثل الكتلة الثانية المتضررين من السياسات التقشفية التي تفرضها بروكسل بدفع ألماني، أما الكتلة الثالثة فهي من المحافظين في أوروبا الشرقية، الرافضين للنهج الليبرالي للاتحاد، والداعين إلى حرية أكبر في قراراتهم في الشؤون الداخلية. والكتلة الرابعة هي الكتلة الغنية التي لا تعاني أزمات اقتصادية، ولديها موقف متحفظ من دول الجنوب، والرافضة لدعمها، أو التوسع بضم بلدان جديدة إلى الاتحاد.
على المستوى العسكري، يعاني الاتحاد الأوروبي غياب الإستراتيجية، وفقدان الثقة بين أعضائه فيما يخص التعاون العسكري. في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على الحلفاء في دفع مساهمات مالية يصفونها بالكبيرة، وهو ما دفع البعض في أوروبا إلى الحديث عن جدوى هذا الحلف مقابل التكاليف الباهظة التي تطالب أمريكا أوروبا بدفعها، وأنه من الأجدى أن تستثمر هذه الأموال في جيش أوروبي يحفظ أمنها، شاطر الرئيس الفرنسي ماكرون أصحاب هذا الرأي في رأيهم، وحذر من مستقبل مظلم لأوروبا إذا ظلت تعتمد على الناتو، قائلا: “الناتو أصبح ميتًا دماغيًّا وفاقدًا لفاعليته”[7]. وشاركت المستشارة الألمانية السابقة ميركل الرئيس الفرنسي التخوف نفسه، داعية أن يقرر الأوروبيون مصيرهم بأنفسهم، وحاجتهم إلى تأسيس جيش أوروبي للدفاع عنهم[8]. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل كرر ماكرون دعوته وأضاف إليها: “أما فيما يخص المظلة النووية، فأوروبا يمكنها أن تعتمد على القدرات النووية العسكرية الفرنسية وتستثمر فيها”[9].
يقف عائقًا أمام هذه الدعوات انقسام الاتحاد من الداخل، وشعور بعض بلدانه بعدم وجود تهديد يستدعي إنفاق المال في جيش أوروبي، وخشية بلدان أخرى من تنامي القوى الأوروبية العسكرية التي ستقودها فرنسا، والاقتصادية لألمانيا، وهو ما يهدد وجودها، ويمكن أن يجعلها تابعة لكلتا الدولتين. كذلك للولايات المتحدة “لوبي” قوي داخل الاتحاد لا يقبل عن أمريكا بديلًا في شؤون الدفاع، مثل بولندا، وبلدان البلطيق.
يرى كثير من المعارضين في أوروبا أنه لا مستقبل لها في ظل تبعيتها للناتو عمومًا، والسياسة الأمريكية على وجه الخصوص، وأن أوروبا أصبحت بين شقي رحى صراع اقتصادي صيني-أمريكي، وعسكري روسي- أمريكي، وهي وحدها من ستدفع ثمنه اقتصاديًّا وعسكريًّا، وإذا حدث صدام مع روسيا، فستكون أوروبا مسرح عمليات الحرب بين كلا الطرفين. على سبيل المثال، حذرت وزارة الدفاع الروسية أوروبا من أن قبولها نشر أمريكا صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى على أراضيها بعد انسحاب الأخيرة من المعاهدة سيؤدي إلى توجيه الجيش الروسي ضربات لها على الأراضي الأوروبية[10]. يشكك هؤلاء المعارضون في إمكانية خلق توافق أوروبي على جيش موحد، ويطالبون بضرورة خلق قوة منفردة، أو بالتوافق مع البلدان المتفقة على هذه التوجه.
لذلك، فإن بناء قوة عسكرية أوروبية- بالنظر إلى الانقسامات الحادة في الاتحاد- يبدو أمرًا صعبًا، وإذا نشأت هذه القوة، يتوقع أن تطرح ألمانيا وفرنسا المشروع الأوروبي للدفاع المشترك من جديد، وإذا لم يجد قبولًا يمكن أن يعود إلى الواجهة المشروع القديم لإنشاء قوة أوروبية مشتركة ألمانية، ورومانية، وبلغارية، تنضم إليها فرنسا، وقد تتشجع بعض البلدان الأخرى بالتدريج على الانضمام إليها[11].
انعكست الأزمات داخل الاتحاد الأوروبي على موقف بلدانه الأعضاء من الأزمة الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن توسع حلف الناتو شرقًا، والحشود العسكرية الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية؛ حيث التزمت بعض البلدان الصمت التام، ولم يصدر عنها أي موقف؛ حرصًا على علاقاتها المميزة مع روسيا، ورفضها للسياسات الأمريكية المتبعة معها، في حين ارتفعت أصوات أخرى تدفع في اتجاه الصدام، مثل بولندا، وبلدان البلطيق، وسط مواقف متحفظة من ألمانيا، ورغبة فرنسية في استغلال الحدث الحالي لإعادة طرح مشروعها بشأن ضرورة إنشاء قوة عسكرية أوروبية، وتأسيس إستراتيجية أمنية موحدة، وهو ما صرح به الرئيس الفرنسي ماكرون، في خطابه أمام البرلمان الأوروبي، في مدينة ستراسبورغ، في 19 يناير (كانون الثاني)[12].
تجنبت فرنسا تقديم أي مساعدات عسكرية مباشرة إلى أوكرانيا، في حين أعلنت ألمانيا صراحةً رفضها تقديم أسلحة لكييف، وبدلًا من ذلك، تعهدت بتقديم مستشفى ميداني لأوكرانيا[13]، ورأت أن الحوار بين أوكرانيا وروسيا، والعودة إلى مسار اتفاقية مينسك، هو الخيار الأفضل، وهو ما دعا كييف إلى استدعاء السفير الألماني، وإبلاغه احتجاجها على هذا القرار، الذي جاء بعد تصريحات للأدميرال كاي آخيم شونباخ، قائد سلاح البحرية الألماني، في اجتماع لم يكن يعلم أنه سيُعرض على وسائل الإعلام، قال فيه: “إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستحق الاحترام، وإن كييف لن تسترد أبدًا شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو”. ومن بين ما صرح به، وله دلالة عميقة تراهن عليها موسكو، قوله: “ألمانيا والهند بحاجة إلى روسيا. إنني مؤمن بالله، ومؤمن بالمسيحية، وإننا دولة مسيحية، حتى وإن كان بوتين ملحدًا؛ فذلك لا يهم. أعتقد بأهمية وجود هذه الدولة الكبيرة إلى جانبنا”[14]. وقد أعتذر القائد العسكري الألماني عن تلك التصريحات، وتقدم باستقالته، أو دُفع إلى تقديمها كما يرى بعض المراقبين.
يوضح هذا الموقف الألماني، وتصريح الأدميرال شونباخ، ورفض برلين أي مقترحات بشأن إعادة النظر في خط نورد ستريم– 2 مع روسيا، وردود الفعل الفرنسية مقابل الحماسة البريطانية في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، ومن خلفها بولندا وبلدان البلطيق، ودعوة التشيك في هذه الظروف إلى تحسين العلاقة مع موسكو، ورد الأخيرة عليها من خلال وزير الخارجية لافروف، بأنها تنتظر “خطوات إيجابية من براغ”[15]، وجود تباين كبير في الرؤى والمواقف، وأن ما يقال عن وجود موقف موحد تجاه الأزمة الحالية لا يعدو كونه كلامًا للاستهلاك الإعلامي.
الموقف الألماني تجاه روسيا مبني على رؤية ألمانية ترى ضرورة احتواء روسيا، وعدم الدخول معها- قدر المستطاع- في أي صدام سترتد نتائجه سلبًا على ألمانيا قبل غيرها.
استغلت ألمانيا تفكك الاتحاد السوفيتي، وسارعت إلى دعم دخول المجر، والتشيك، وسلوفاكيا، وبولندا، وبلدان البلطيق، إلى جانب بولندا، في الاتحاد الأوروبي، وربطها اقتصاديًّا بها؛ لخلق قوة مستقرة عازلة بينها وبين روسيا، وكانت متحمسة لتفكيك تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا؛ لتصبح القوة الأوروبية الأكبر.
تعتقد ألمانيا أن الدعوة إلى مقاطعة روسيا، واستبدال الغاز الأمريكي أو القطري المسال بالغاز الروسي- كما تسرب من وجود رغبة أمريكية في ذلك الأمر- تصرف غير حكيم، وسيؤدي إلى مزيد من العدوانية في السياسية الروسية، وأن وجود مصالح اقتصادية لروسيا من خلال تصدير أهم سلعة توفر الأموال لخزينتها، وهي الغاز، وسيلة مناسبة لضبط سياساتها، وورقة في يد أوروبا يمكن أن تلوح بها عندما تتخذ موسكو مواقف صدامية، كما تفعل الآن برلين بالتهديد بإيقاف خط نورد ستريم-2، إذا غزت روسيا أوكرانيا.
الحكومة الألمانية الحالية، وحتى السابقة في عهد المستشارة ميركل، لم تكن حكومة أغلبية، في وضع داخلي مستقر يمكنها من اتخاذ سياسات تصعيدية تجاه موسكو، التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع بعض الأطراف السياسية التي باتت مؤثرة داخل البوندستاغ (البرلمان الألماني)، من أقصى اليسار واليمين، ولديها مصالح تجارية أيضًا مع أطراف ألمانية مؤثرة، وهو ما قد يعرض الداخل الألماني لخطر الانقسام، وربما انهيار الحكومة الائتلافية.
ألمانيا، العملاق الاقتصادي، الضعيفة عسكريًّا، لا ترغب في مواجهة داخل أوروبا، ستؤثر بالسلب في إستراتيجيتها الاقتصادية، وربما تُسهم في مزيد من صعود الصين الاقتصادي الذي يشكل قلقًا لها، وترى أن موسكو يمكن أن تشكل عامل حسم في المواجهة مع بكين، وضرورة عدم قطع كل طرق التفاهم معها.
فرنسا، الضعيفة اقتصاديًّا، المتراجع تأثيرها السياسي والثقافي في أوروبا ومستعمراتها السابقة، تحاول أن تستغل قدراتها العسكرية الكبيرة في تعزيز مكانتها، واختيار طريق ثالث، بعيدًا عن الناتو، والصدام مع موسكو، أو التسليم بما تريده بالضرورة، وإقناع الأوروبيين بإستراتيجية عسكرية موحدة ستدفعها- بحكم وزنها العسكري الكبير- إلى مركز الصدارة، وهو ما يلقى حتى الآن معارضة من باقي دول الاتحاد الأوروبي، وقبولًا ألمانيًّا معلنًا، لكنه غير جاد كما يبدو.
بلدان أوروبا الشرقية والبلطيق لا تثق بأي مظلة أمنية خارج نطاق سيطرة الولايات المتحدة، مع اعتقاد يسود هذه البلدان أن هيمنة فرنسية- ألمانية، ذات قوة عسكرية بجانب الاقتصادية، ربما تشكل لها عنصر أمان من روسيا، ولكنه سيجعلها تابعة لهذا التحالف الثنائي بين باريس وبرلين، وهو ما يدفعها إلى التمسك بالتعاون الحصري مع واشنطن.
رغم الدعم البولندي لأوكرانيا، فإن وارسو تريد أن تحجز لنفسها موقع نفوذ قوي داخل هذا البلد الذي ترى أن جزءًا من أراضيه تم اقتطاعه من الروس ومنحه له، وبالتحديد في منطقة غرب أوكرانيا، وعاصمته لفيف، ذات الأغلبية الكاثوليكية، والثقافة الأقرب إلى بولندا، التي تفصلها 50 ميلًا فقط عن الحدود البولندية، في حين لدى المجر، بقيادة فيكتور أوربان، طموحات في منطقة زاكارباتسكا، أقصى غرب أوكرانيا، الكاربات، وموقف متقارب مع روسيا بشأن حقوق الأقليات القومية؛ حيث تسكن في هذه المنطقة أقلية مجرية كبيرة، يطمح في استعادتها على غرار “استعادة” روسيا للقرم، كما تقوم السلطات المجرية بالتكتيك الروسي نفسه؛ ألا وهو منح الجنسية المجرية لسكان المنطقة[16].
تراهن موسكو على هذا الانشقاق الأوروبي، وتعمل على تغذيته، واستغلال حلفائها داخل الاتحاد من أحزاب وشخصيات عامة، وقيادات سياسية، مع ضعف أوروبا العسكري، والتحديات التي تواجهها في الداخل بشأن القضايا الاقتصادية، والهجرة، والهوية، والتنافس مع الصين، وتأرجح السياسية الأمريكية، في أن تصل القوى المؤثرة الأوروبية- في نهاية المطاف- إلى صفقة منفردة مع موسكو بمعزل عن الولايات المتحدة، أو تقسيم أوروبا بما يفقدها القدرة على الفاعلية.
تقدم روسيا مقترحًا لأوروبا قائمًا على توفير فرص استثمارية ضخمة يمكن أن تعيد إنعاش الاقتصاد الأوروبي إنعاشًا كبيرًا، وتخلق توازنًا حقيقيًّا مع الصين وصعودها الاقتصادي القوي، إلى جانب إمدادات الطاقة، والتعاون في حل أزمات الشرق الأوسط، التي ترتد على أوروبا بتحديات مختلفة، أهمها الإرهاب، وتدفق اللاجئين، مقابل سياسة أمنية مشتركة تضمن مصالح روسيا.
تقف أوروبا اليوم حائرة، وغير قادرة على حسم خياراتها؛ بالتوجه نحو روسيا، والتفاهم معها على سياسة أمنية واقتصادية وسياسية في القارة، أو السير خلف السياسة الأمريكية التي أصبحت عصية على التوقع، وتشهد تغييرات مفاجئة، وسط تحديات داخلية، وتغول اقتصادي صيني، وهو ما نتج عنه- في المحصلة النهائية- ضعف سياسي لدورها في الأزمة الحالية، التي تبدو فيها غائبة عن المفاوضات الروسية الأمريكية، وأصبح حضورها شرفيًّا، بلا فاعلية حقيقية.