
العنوان الأصلي لهذا الكتاب هو “من روس إلى روسيا”، وقد عدّله المترجمون إلى “تاريخ روسيا”، ثم أضافوا إليه عنوانًا فرعيًّا هو “من القبيلة إلى الدولة”. ومؤلف هذا الكتاب لم يجمع مادته من المراجع في غرفة مكيفة مغلقة (أو بالأحرى في غرفة مغلقة أمام المدفأة في شتاء روسيا البارد)؛ بل كان صانعًا للمعرفة، ومنبعًا أوليًّا للمعلومة، وراسمًا لمسار الفكرة والخريطة.
وقد صدرت النسخة العربية من الكتاب في عام 2021، عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة، وهي من إعداد عاطف معتمد، وسعد سيد خلف، ووائل فهيم.
“ليف غوميليوف” هو أحد أشهر الجغرافيين في الاتحاد السوفيتي خلال القرن العشرين (ولد في سانت بطرسبورغ، في أكتوبر 1912، وتوفي في المدينة نفسها في يونيه 1991). يحظى بشهرة مرموقة بوصفه مؤرخًا، وجغرافيًّا رصينًا، وباحثًا رائدًا في كل من الأركيولوجيا، والأنثروبولوچيا الثقافية.
وُلد لشاعرين كبيرين في تاريخ الأدب السوفيتي: الأب نيقولاي غوميليوف، والأم أنــَّا أخماتوڤا. للأسرة كلها كفاح سياسي بين الصعود والاضطهاد. تعرض ليف للاعتقال أربع مرات في عهد ستالين؛ بسبب آرائه السياسية المناهضة للاستبداد، كانت الثالثة منها عقوبة السجن خمس سنوات، وكانت المرة الرابعة عام 1949، وحكم عليه فيها بالسجن عشر سنوات.
وحين أفرج عنه بعد موت ستالين استأنف ليف غوميليوف منذ 1956 مسيرته العلمية، والتحق بالعمل في كل من متحف الإرميتاچ، وجامعة لينينغراد (سانت بطرسبورغ).
يعد غوميليوف أحد أشهر من جمع بين وجهيّ العملة في الدراسات الحضارية: الجغرافيا والتاريخ، وطبق ذلك على تاريخ شعوب الخزر، وبحر قزوين، وقبائل السهوب في وسط آسيا، في القطاع الواصل بين قارتي أوروبا وآسيا حتى اشتهر بلقب “الأوراسي العظيم”، وما من عجب في ذلك، وقد أعدّ رسالتين للدكتوراة: الأولى في التاريخ (1961)، والثانية في الجغرافيا (1974).
لم يكن التأهيل العلمي لغوميليوف نابعًا من قراءة صامتة في الكتب والمراجع؛ بل من خلال مشاركته في بعثات التنقيب الأثري، وقد شارك في 21 بعثة أثرية خلال المدة من عام 1931 حتى عام 1967.
أهم اكتشافات غوميليوف الأثرية كانت في منطقة مصب نهر الفولغا في بحر قزوين، وهي المنطقة المعروفة في التاريخ بأنها مركز حضارة مملكة الخزر التي قام عليها جانب مهم من تفسير تاريخ روسيا.
ترك ليف غوميليوف تراثًا علميًّا كبيرًا قوامه اثنا عشر كتابًا، وأكثر من مئتي بحث ومقال علمي.
على الرغم من مكانة روسيا بوصفها قوة عظمى في حقب طويلة، أو قوة إقليمية كبيرة تشارك في صنع القرار العالمي، فإن روسيا التي نعرفها اليوم بهذا القدر وتلك المكانة، لم تكن في الأصل سوى مجموعة من القبائل البدائية التي عاشت حياة متخلفة بائسة في شرق أوروبا، واحترفت القنص، والصيد، والإغارة، وقطع الطريق. كانت هذه القبائل تحمل اسم “روس”، وعرفت في بعض المصادر الأجنبية خارج روسيا باسم “روث”، وحمل المنتمي إلى هذه القبائل اسم “روثيني”، أو “روسي”.
وإذا كان العالم قد سمع بالروس قوةً مؤثرةً في التاريخ منذ القرن السادس عشر، أي إن عمر روسيا بوصفها لاعبًا في التاريخ لا يزيد على خمسة قرون، فإنها عاشت حياتها قبل ذلك التاريخ، وبصفة خاصة منذ القرن السابع الميلادي، في مكانة ثانوية، تتأثر بالقوى المحيطة بها، وتخضع لها، أو تعمل لحسابها.
وحين نقول “تعمل لحسابها” فإننا لا نقع في أي تجاوز بوصفها بالمرتزقة أو الأجيرة، فهذه كانت كلمات المؤلف نفسه حين استخدمها لضرب أمثلة عدة عن الدور الذي اضطلعت به القبائل الروسية للقيام بحملات عسكرية مدفوعة الأجر لصالح القوى المجاورة، ومن بينها مملكة الخزر، التي توسطت الموقع الجغرافي بين بحر قزوين (بحر الخزر) والبحر الأسود.
كانت هذه القبائل في الأصل جزءًا من مجموعة عرقية أكبر تحمل اسم “سلاڤ Slav”، انتشرت في كل المنطقة الفاصلة/الواصلة بين آسيا وأوروبا من بحر البلطيق في الشمال حتى البحر الأسود في الجنوب.
أشارت كثير من المصادر التاريخية العربية إلى هذه الشعوب السلافية باسم “الصقالبة”، وهو اسم يبدو أنه محرف عن النطق اليوناني “صكيلاب”، الذي هو تنويع على اسم “سلاڤ Slav”.
ومن بين العناصر السلاڤية (الصقلبية) كافة، تمكنت قبائل “روس” من الانتشار والتماسك، وبناء وحدة سياسية.
الحقيقة أن الروس- اعترافًا منهم ببدائية حياتهم، وضعف قدرهم، وانقسامهم على أنفسهم- استعانوا بشعوب أكثر قوة وتنظيمًا، وطلبوا منهم أن “يحكموهم”، وهو نمط فريد في القبول الطوعي بتسليم الإدارة والسلطة إلى من هم أكثر قدرة على ذلك من غير أبناء الوطن.
على هذا النحو، وصل في عام 862 م من شبه جزيرة إسكندناوة، القائد روريك، ومعه أفواج من القبائل الفارانجية (من الفايكنج)، واتخذوا من مدينة “نوفغورود” مركزًا ليحكموا منه الإقليم الذي تنتشر فيه القبائل السلافية.
كان الفارانجيون “برابرة” ومحاربين أشداء أجراء أسسوا في “نوفغورود”- وهي مدينة شمالية غير بعيدة عن بحر البلطيق- نظامًا للقبائل الروسية، ثم سرعان ما نقلوها في مطلع القرن العاشر إلى مدينة أفضل في الطبيعة، والمناخ، وتوسط الموقع الجغرافي، هي “كييف”، على نهر الدنيبر.
وسيطلق المؤرخون على تاريخ القبائل السلافية حول كييف اسم عصر “روس كييف”، وستصبح تلك المدينة “أم المدائن” في شرق أوروبا، وفيما بين القرنين العاشر والحادي عشر سيستمر صعود “روس كييف” قويًّا، قرنين من الزمن، قبل أن ينقل الأمراء الروس الموقع إلى موسكو، ويعرف تاريخ روسيا مرحلة أو عصرًا جديدًا يسمى “روسيا الموسكوفية”، بداية من القرن الثالث عشر.
جدير بالذكر أن كييف لم تتأسس من العدم، فالأرجح أنها كانت في الأصل محطة أسسها أمراء دولة الخزر (تلك التي امتدت فيما بين البحر الأسود وبحر قزوين، وبلغت ذروة اتساعها في القرن الثامن الميلادي)، واتخذ الخزر من كييف نقطة تجميع الجزية على نهر الدنيبر.
سيظل الروس أسرى لهيمنة الخزر إلى أن يتمكنوا من إنزال هزيمة بهم، والتحرر من نفوذهم في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي، ليصبح الطريق ممهدًا أمام القبائل الروسية إلى محور بحر قزوين، الذي كانت إمبراطورية الخزر قد أغلقته عبر قرون.
شهدت المراحل التي ستمر بها القبائل الروسية منذ القرن العاشر الميلادي لبناء دولة فصولًا قاسية كي تجد لنفسها مكانًا بين الأمم المجاورة. كانت أهم الأمم المجاورة ممثلة في العالم الإسلامي (وعاصمته بغداد)، والعالم المسيحي ممثلا في بيزنطة، وعاصمتها تسارغراد (مدينة القيصر) المشهورة لاحقًا باسم القسطنطينية.
ومن الشمال كانت هناك قوة أكبر ممثلة في السويد، وليتوانيا، وبولندا، ومن الغرب كانت هناك بروسيا، ومن الجنوب الإمبراطورية البيزنطية، ومن الشرق مملكة الخزر، ثم الإمبراطورية المغولية، ومن وراء ذلك كله العالم الإسلامي الذي تمكن من الوصول إلى مشارف الأراضي التي ينتشر فيها الروس في البحر الأسود، والقوقاز، ووسط آسيا.
من حيث المزايا، يتناول الكتاب سلسلة شاملة من أسماء الشعوب والقبائل التي أسهمت في تكوين روسيا كدولة، وشعب، وحضارة. هذا الحصر الشامل لكل شاردة وواردة في تاريخ روسيا منذ أن كانت قبائل هائمة على وجهها حتى بلوغها مصاف الدول القوية على الساحة الدولية، سيرهق- من جانب آخر- القارئ غير المعني بالتاريخ “الوطني”.
التاريخ الوطني هو ذلك التاريخ الذي يضعه مؤلف، ويقرؤه أبناء وطن واحد؛ ولذلك تكثر في عبارات مؤلف هذا الكتاب صفة الانتساب، فنقرأ دومًا “وطننا”، و”شعبنا”، و”أمتنا”، و”أرضنا”، وهو ما دفع المترجمين- في بعض الأحيان- إلى تغيير طفيف في هذه العبارات لتناسب القارئ العربي، لتصبح “الشعب الروسي”، و”الوطن الروسي”، و”التاريخ الروسي”.
هذا النوع من التاريخ “الوطني” مفيد جدًّا لأبناء روسيا، ولكنه قد يبدو ثقيلًا على القارئ خارج هذا الوطن الروسي، وستبدو الأسماء ثقيلة، وربما مرهقة، والتفاصيل كثيرة للقارئ العربي.
ويعد الدين لوحة مهمة من لوحات تاريخ روسيا منذ أن كانت قبائل تعبد الأوثان. أزمة هذه القبائل أنها كانت تعبد أوثانًا تتطلب تضحيات وقرابين بشرية دموية؛ مما جعل الكثيرين يخشون هذه الآلهة ولا يحبونها. وحينما حاولت القبائل أن توحد نفسها في القرنين الثامن والتاسع، وجدت أزمة تبعثر الانتماء على أوثان وآلهة متنوعة؛ من هنا كان لا بد من البحث عن دين يوحد هذه القبائل المبعثرة في كيان واحد. يأخذنا المؤلف إلى حيرة الأمراء الروس في البداية تجاه الديانات التوحيدية الثلاث (اليهودية- المسيحية- الإسلام)
لأسباب مختلفة- سنعرفها من الكتاب وصفحاته الجادة- اختار الزعماء الروس منذ مطلع القرن الحادي عشر المسيحية دينًا للقبائل الروسية الوثنية، وفرضوه عليهم، ووقعت حالات صدام عنيفة بين أتباع الأوثان وأتباع الديانة الجديدة، حتى انتصرت الدولة في فرض دينها الجديد، وتغيرت مسيرة الدولة ومحاور تحالفاتها، ولم تحقق أهدافًا روحية لشعوبها فقط؛ بل حققت أهدافًا سياسية وإدارية في المقام الأول.
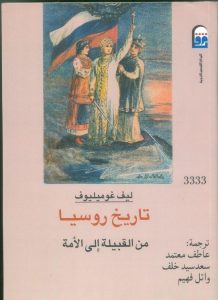
بالإضافة إلى المعلومات التي يتحفنا بها المؤلف، والخرائط التي يزودنا بها، يصوغ لنا أطروحته التي اشتهر بها في علم الجغرافيا التاريخية، والتي يمكن أن نسميها أطروحة “الشغف الخلَّاق في الفضاء الأوراسي”. تقوم هذه الأطروحة على عمودين:
على هذا النحو، فإن غوميليوف كان يتناول في كتابه تاريخ روسيا من حيث إنه في الحقيقة تاريخ للشغف الخلاق للشعوب الأورآسيوية.
لا يوقف المؤلف قصة الشغف الخلَّاق على أسلاف الروس من القبائل السلافية التي سيطرت على شرق أوروبا؛ بل يعود إلى ما قبل هذا التاريخ بأكثر من ألف عام، متتبعًا الفصول المتلاحقة من دفقات الشغف الخلَّاق ودفعاته التي انتشرت في آسيا وأوروبا، أو في “أوراسيا” بمعنى أشمل، وأكثر اندماجًا.
يأخذنا المؤلف مع رحلة شعوب “الخون” وأحفادهم من “الهون” الذين انتشروا من أقصى الشرق الآسيوي، ووصلوا إلى القارة الأوروبية رابطين وموحدين ومهيمنين على الفضاء الأوراسي. وفعل المؤلف الشيء نفسه، متتبعًا مسيرة القوط، والبچناك، والبولغار، والقبائل التي انضوت تحت حكم اليهود الخزر، وموجات الزحف المغولي.
هذا الكتاب أيضًا من الكتب النادرة التي تؤصل لجذور علاقة اليهود والروس منذ القرن العاشر الميلادي، وتدخلهم في شؤون روسيا خارجيًّا وداخليًّا.
كان سقوط كييف عام 1240 في يد المغول مرحلة جديدة لما ستعرفه روسيا فيما بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر. لكن على خلاف ما تبناه بعض المؤرخين في روسيا من أن غزو المغول كان نقمة وإذلالًا للقبائل الروسية، وأخذها إلى مصاف التخلف، ينتمي مؤلف كتابنا الحالي، ليف غوميليوف، إلى الرواد الذين قبلوا تعبير “لولا المغول لما قامت روسيا”، الذي صكه المفكر الروسي سافيتسكي (عام 1922)، معتبرًا أنه بفضل “القبيلة الذهبية” التترية اكتسبت روسيا استقلالها الجيوسياسي، وحافظت على استقلالها الروحي من عدوانية العالم الروماني الجرماني الغربي المسيحي المتغطرس.
ينتمي غوميليوف إلى تأثير سافيتسكي، وغيره من العلماء ممن يردون الاعتبار لـلتأثير الآسيوي المغولي والتتري والتوركي بوصفه مفهومًا حضاريًّا وجيوسياسيًّا مميزًا عن التأثير الأوروبي في الغرب. في هذا السياق، استفاد الروس من النظام الإداري الذي جلبه المغول من حضارات الشرق، خاصة الحضارتين الصينية والإسلامية (لا سيما الحضارة الفارسية).
وخلاصة أطروحة العامل المغولي المؤثر في تاريخ روسيا تقوم على دحض المقولات السابقة عن الإذلال المغولي، لتطرح محلها فرضية سافيتسكي وغيره من أن روسيا هي وريثة الخانات المغولية العظمى، ومكملة إنجازات جنكيز خان وتيمورلانك، وهي بهذا موحدة الفضاء الأوراسي معًا.
تبنى غوميليوف- في هذا الكتاب، وفي غيره من أعماله السابقة- رد الاعتبار للمكون الآسيوي، وإسهامه في تكوين الدولة الروسية من خلال التعاطف تجاه الثقافات البدوية في أوراسيا. وفي مؤلفاته السابقة على هذا الكتاب، تبني غومليوف مصطلح عصر “الفتوحات المغولية”، رافضًا وصفها بـ”النير المغولي”، معتبرًا أنه بفضل “القبيلة الذهبية” والمبادئ الاجتماعية لـقانون “ياسا” الذي وضعه جنكيز خان، تشرّب الروس العظماء تقاليد البناء الإمبراطوري، وحافظوا على الهوية الأرثوذكسية؛ ما مكنهم بعد ذلك من بناء إمبراطورية عالمية.
التعبير الأوراسي الذي ينضوي على بعض غموض لمن لا يعرفون تفاصيل خريطة أوراسيا، يمكن التعبير عنه- على نحو مبسط- بأن روسيا تقدم نفسها على المسرح الدولي بوصفها حضارة “شرقية/ غربية”، أي تجمع بين خصال الشرق الآسيوي وسمات الغرب الأوروبي.
هذا الجمع يقدم أزمة وفرصة في الوقت نفسه؛ فهو أزمة حين تحاول روسيا ضم هذا التنوع الكبير المتشابك والمعقد في تفاصيل حضاراته الفرعية، وتنوعات لغته وثقافته، داخل حدود بيت واحد كبير اسمه البيت الروسي (وفي تسمية البيت بالـ”روسي” إغفال لهوية أسماء عشرات الأعراق الأخرى المضطرة أن تنسب نفسها إلى الهوية الروسية).
أما الفرصة فكامنة في هذا الثراء الطبيعي للأرض التي ضمتها روسيا بالتوسع والحرب على حساب هذه الأعراق، وما تحويه هذه الأرض من معادن وخيرات، فضلًا عمن يعيش عليها من شعوب وحضارات متنوعة تثري الحضارة الروسية، وتدعمهما، وترفدها بروافد إبداعية لا نهاية لها، وتجعل منها ما يسميه مؤلف هذا الكتاب “شعبًا فائقًا”، أو ما يقوله حرفيًّا في اسم “السوبر إثنوس”، أي “العرق السوبر”.
الكتاب الذي بين أيدينا هو مرجع أساس تعرفه الأوساط الثقافية والعلمية والأكاديمية في روسيا بأنه من أشهر كتب التاريخ والحضارة، وإضافته إلى المكتبة العربية أمر مهم ومفيد، مع التسليم بأننا نتوقع من القارئ العربي صبرًا على أسماء الأماكن الكثيرة، وأسماء الأمراء والملوك والشخصيات التي يحفل بها الكتاب، والتي يشبه بعضها بعضًا، وتختلط أحيانًا على العين غير المدربة.
ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير.